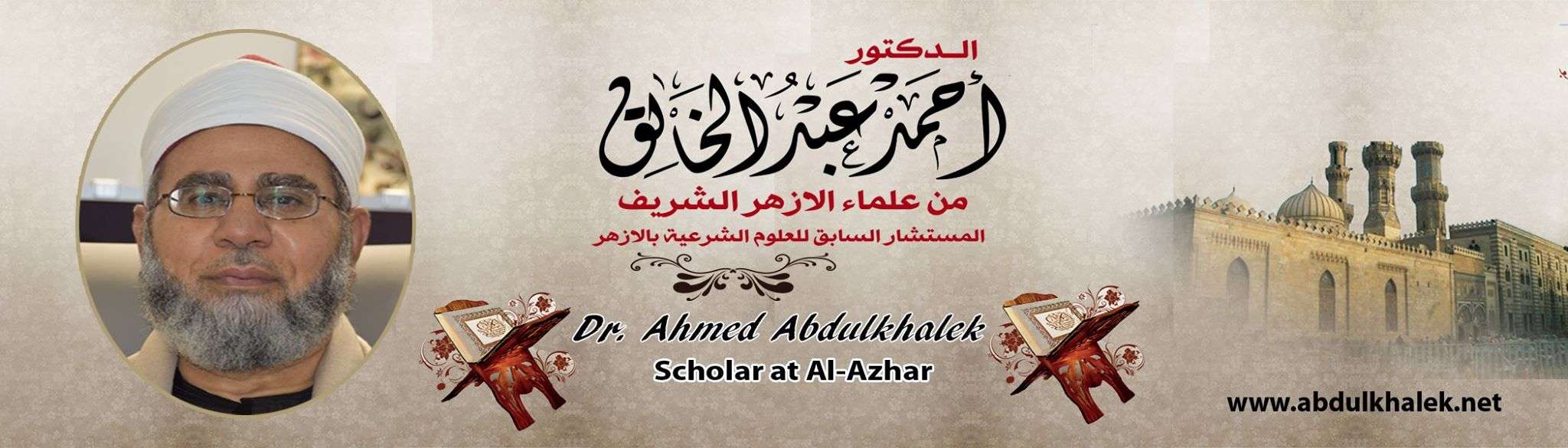الحلقة
السابعة عشر من التأملات القرآنية
بقلم
د. أحمد عبد الخالق
جزاء
الطاعة: طاعة. وجزاء المعصية: معصية.
حمدا لله تعالى،
وصلاة وسلاما على سيدنا وحبيبنا رسول الله r
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه، واتبع هديه إلى يوم الدين. وبعد
فإن تأملاتنا في هذه
الحلقة، سوف تدور حول الطاعة، وثوابها المتمثل في توفيق تعالى الله للعبد
في الدخول في طاعة أخرى. ويظل العبد، كلما أطاع الله، دخل في طاعة غيرها، حتى يلقى
الله تعالى، وهو على طاعة. وكما أن ثواب الطاعة: طاعة، فإن جزاء المعصية: معصية.
فكلما عصى العبد مولاه ولم يتب ، عوقب على معصيته بدخوله في معصية أكبر، ويظل
العبد على هذه الحال، حتى يلقى الله تعالى وهو على معصية.
وبهذا المعنى جاءت
الآيات القرآنية، حيث يقول الله تعالى: ]ُقلْ
مَنْ كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً حَتَّى إِذَا
رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ
مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضْعَفُ جُنْداً . وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ
اهْتَدَوْا هُدىً وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً
وَخَيْرٌ مَرَدّاً[ ([1])
وقال تعالى: ]وَالَّذِينَ
اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ[([2])
وقال تعالى: ]الَّذِينَ
كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ
بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ[([3])
أي من كان مستقرا في
الضلالة، مغمورا بالجهل والغفلة عن عواقب الأمور ]
فليمدد له الرحمن مدا[ أي يمد سبحانه له ويمهله بطول العمر وإعطاء
المال، فيكون حاصل المعنى من كان في الضلالة فلا عذر له، فقد أمهله الرحمن، ومد له
مدا. ويجوز أن يكون ذلك للاستدراج كما ينطق به قوله تعالى ]
إنما نملى لهم ليزدادوا إثما[
وحاصل المعنى من كان في الضلالة، فعادة الله تعالى أن يمد له ويستدرجه، ليزداد إثما.
ومعنى ذلك، أن الله سبحانه
وتعالى، يعاقب الضالين، الذين سلكوا طريق الغواية، ووقعوا في المعاصي، يعاقبهم
الله تعالى على ذلك بطول العمر، وتحقيق مطالبهم الدنيوية، استدراجا لهم، فهو
سبحانه ينعم عليهم، لينتقم منهم. وهذا هو الاستدراج، فهم يظنون أن الله راض عنهم،
ولولا ذلك ما أنعم عليهم، فيتمادون في الذنوب والمعاصي، وهذا هو الغضب بعينه. وهذا
هو ما أشار إليه القرآن، حيث قال: ]فَذَرْنِي
وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ
. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ[
([4])
فأصول الخطايا، التي
يقع فيها الضالون: ثلاثة:
أ- الكبر،
وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره.
ب-
والحرص، وهو الذي
أخرج آدم من الجنة.
ت-
والحسد، وهو الذي جرأ أحد ابني آدم على أخيه.
فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر، فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي
والظلم من الحسد.
ومن هنا فإن المغضوب
عليه من الله، تراه يكره الطاعة والطائعين، ويضيق صدره من مجالسة الصالحين، ويغضب
إذا ذكر بآيات الله رب العالمين. وإن المرضي عنه من الله تعالى، يحب الطاعة، ويشكر
من يدله عليها، ويعشق مجالسة الصالحين، وينشرح صدره للإسلام، ويطمئن قلبه لذكر
الله تعالى، وتراه سباقا إلى الخيرات. ويضيق صدره من أهل الفسق والطغيان. فالأرواح
الطيبة، يحب بعضها بعضا وتتآلف وتتعارف. والأرواح الخبيثة تتآلف وتتعارف. وكما
يقال: الطيور على أشكالها تقع. ولما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله r: [الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف ]([1])
وهذه
الآيات تشير إلى ذلك: ]فَمَنْ يُرِدِ
اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ
يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي
السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ[([2])
وقال تعالى: ]أَفَمَنْ شَرَحَ
اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ
لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ[([3])
أما المهتدين الطائعين، فأولئك يمن عليهم ربهم بالهداية الدائمة ويثبتهم
على الحق، ويهديهم صراطه المستقيم. وهناك لفتة لطيفة في قوله تعالى:
]وَالَّذِينَ
اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ[([4]) وهي أن الذين اهتدوا بدأوا هم بالاهتداء, فكافأهم الله بزيادة الهدى, وكافأهم بما
هو أعمق وأكمل: ]وَآتَاهُمْ
تَقْوَاهُمْ[. والتقوى حالة في القلب تجعله أبدا واجفا من هيبة الله, شاعرا برقابته, خائفا من غضبه، متطلعا إلى رضاه, متحرجا من أن يراه الله على هيئة، أو في حالة لا يرضاها. هذه
الحساسية المرهفة هي التقوى. وهي مكافأة يؤتيها الله من يشاء من عباده, حين يهتدون هم، ويرغبون في الوصول إلى رضى الله.
ومن هنا، فإنهم يوفقون للباقيات الصالحات. وأيا كان تفسيرها، فهي تشير إلى جميع الأعمال الصالحة، التي تبقى لصاحبها
يوم القيامة، وتقيه وتدفع عنه عذاب الجحيم، وذلك لقول رسول الله r في الحديث
الصحيح:
[خذوا جُنتَكم من النار. قولوا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله،
والله أكبر. فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات، ومعقبات، ومجنبات، وهن الباقيات الصالحات]([5])
فمن استطعم تلك الكلمات، وكانت على لسانه خفيفة، وعلى قلبه لطيفة، وعاش معانيها،
وتأمل مبانيها، فإن الله تعالى يفتح له أبواب القبول، ويوفقه للعمل بما يقول.
يقول ابن القيم في هذا المجال: "تكرر
في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال، فيقوم
بالقلب والجوارح أعمال تقتضي الهدى، اقتضاء السبب لمسببه والمؤثر لأثره، وكذلك
الضلال، فأعمال البر تثمر الهدى، وكلما ازداد منها ازداد هدى، وأعمال الفجور
بالضد، وذلك أن الله سبحانه يحب أعمال البر، فيجازي عليها بالهدى والفلاح. ويبغض
أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء.
وأيضا فإنه البَر ويحب أهل البِر، فيقرب قلوبهم
منه بحسب ما قاموا به من البر. ويبغض الفجور وأهله، فيبعد قلوبهم منه بحسب ما
اتصفوا به من الفجور، فمن الأصل قوله تعالى : ] الم . ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً
لِلْمُتَّقِينَ[([6])
وهذا يعني: أنه يهدي
به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب. فإن الناس على اختلاف مللهم ونحلهم قد استقر
عندهم أن الله سبحانه، يكره الظلم والفواحش والفساد في الأرض، ويمقت فاعل ذلك.
ويحب العدل والإحسان والجود والصدق والإصلاح في الأرض، ويحب فاعل ذلك. فلما نزل
الكتاب، أثاب سبحانه أهل البر بأن وفقهم للإيمان به، جزاء لهم على برهم وطاعتهم،
وخذل أهل الفجور والفحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء به.
إذن لا بد أن يكون
للسعادة أصول تقوم بها وترتكز عليها. وقد أشار إليها ابن القيم في الفزائد فقال: إنما
يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد، من تركها لغير الله، أما من تركها صادقا
مخلصا من قلبه لله، فإنه لا يجد في تركها مشقة، إلا في أول وهلة، ليمتحن أصادق هو
في تركها أم كاذب ؟، فإن صبر على تلك المشقة قليلا، استحالت لذة.
قال ابن سيرين:
سمعت شريحا، يحلف بالله، ما ترك عبد لله شيئاً، فوجد فقده. وقولهم : [من ترك
لله شيئا عوضه الله خيرا منه] حق، والعوض أنواع مختلفة ، وأجلّ ما يعوض به:
الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى.
أغبى الناس من ضل في
آخر سفره وقد قارب المنزل.
العقول المؤيدة
بالتوفيق، ترى أن ما جاء به الرسول r
هو الحق الموافق للعقل والحكمة. والعقول المضروبة بالخذلان،
ترى المعارضة بين العقل والنقل، وبين الحكمة و الشرع.
أقرب الوسائل إلى
الله، ملازمة السنة، والوقوف معها في الظاهر والباطن. ودوام الافتقار إلى الله،
وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله، إلا من هذه الثلاثة.
وما انقطع عنه أحد، إلا بانقطاعه عنها، أو عن أحدها.
الأصول التي انبنى
عليها سعادة العبد ثلاثة: ولكل واحد منها ضد. فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده:
التوحيد، وضده الشرك. والسنة، وضدها البدعة. والطاعة، وضدها المعصية. ولهذه
الثلاثة ضد واحد وهو خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده، ومن الرهبة منه ومما
عنده.
أخي الحبيب، عش مع
الله بقلبك وجوارحك، وتدبر كتابه الكريم، وتأمل ملكه وملكوته العظيم، وتعرف على
أسرار عظمته، وأسباب رحمته، وسارع إلى الله تعالى بالطاعات، وبادر إلى الله تعالى
بالتوبة من المعاصي والسيئات، فإن الله تعالى يجب التوابين ويحب المتطهرين. واغتنم
أيام الله، وتعلق به، والجأ إليه، ولذ بجنابه الكريم، وقل له: يا حي ياقيوم، يا
بديع السماوات والأرض، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، لا
يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر
المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء
الخائف الضرير، مَن خضعت لك رقبته، وفاضت لك عبرته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه. اللهم
لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسئولين، ويا خير المعطين.
وصل اللهم وسلم وبارك
على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.